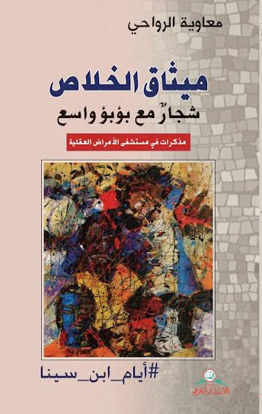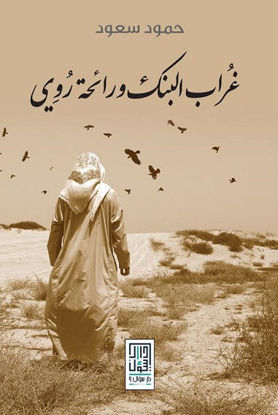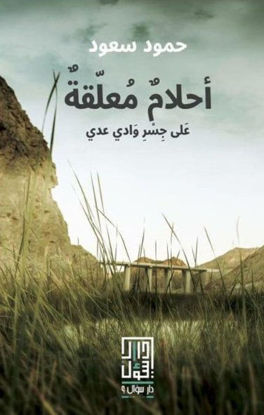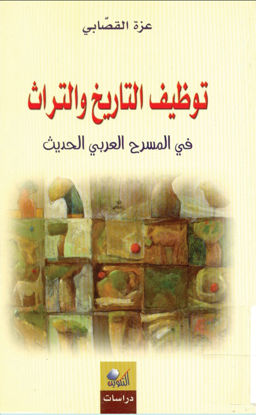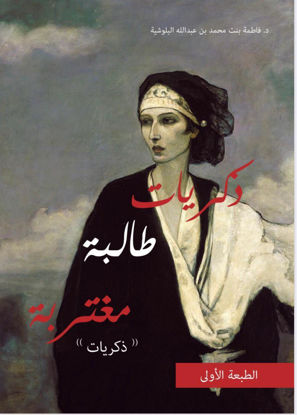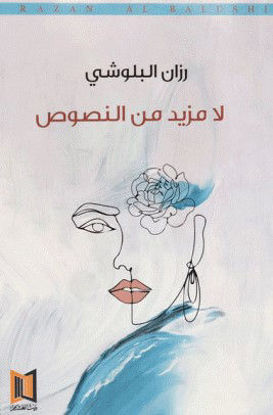لا يوجد منتجات فى سلة التسوق
آداب وفنون
سيرة المهندس الذي أستعمره الغبار
لكن المهندس علي أصبح يمشي بتؤدة يثير الغبار تحت قدميه.. يخوض هذا الغبار وحده ، يجاهد كي لا يختنق ، يحاول رفع أنفه لتكون فوق مستوى الغبار، يستنشق ويزفر بسرعة خاطفة كي يخزن بعض الهواء النقي في رئتيه.. يتحدث بصوت مسموع لأشخاص يراهم وحده، يصنعهم في الأثير المحيط به لكي ينفث مخزون الحديث الذي لا ينفد أبدا، محاولا نفض الغبار المتكدس في عالمه الخفي. - غبار يا خي.. في عقولكم غبار. نعم مات.. وهذا الذي يتدحرج أمامنا ما هو الا جسد استعمره الغبار، وأنا لا أريد أن أموت مثله.. لا أريد..
1.000 ر.ع.
ميثاق الخلاص ؛ شجار مع بؤبؤ واسع ؛ مذكرات في مستشفى الأمراض العقلية
الجميع يحلل ويحاول الفهم. فاقد الشيء لا يعطيه. وما اعتدته منذ صغري هو أنني أشعر لا أكثر. أشعر أكثر فأكثر حتى أكتشف الحياة التي أصبحتها اليوم. لماذا يبدو السجن أبسط مشاكلي الأن؟ كنت بحاجة لهذا الدفتر لأستطيع التفكير.
2.000 ر.ع.
غراب البنك رائحة روي
في السادسة والنصف من هذا المساء لن يعبر غراب الربع الخالي فوق مبنى البنك المركزي في الحي التجاري بروي؛ لأنه لسنوات طويلة تلا وصاياه، وصرخ في وجه الكارثة، وقال للبلاد والعباد ما يقوله الشاعر للقصيدة، ما تقوله الرصاصة للقتيل، ما تقوله الشجرة لناي الصوفي، ما تهمس به الجبال للرعاة والجفاف، ولكن البلاد والعباد اتهموم بالجنون والحسد والخيانة.
1.500 ر.ع.
أحلام معلقة على جسر وادي عدي
مسقطك أيها المجنون المتسرد/المتشرد/المنفي. لا شـيء يوقظها، لا الـكلام، ولا غراب البنك المركـزي، ولا برج الصحوة، ولا كورنيش مطرح، ولا القراصنة، ولا القتلة، ولا الشهداء، ولا دوار الحاجـر، ولا حزن نادلة في مقهى على بحر عمان، ولا فرح شجرة في القرم يحط عليها طائر أعمى، ولا قلق بائع سمك في سوق السيب، ولا رائحة مدوخ بدوي في مواقف مستشفى خولـة، ولا نص يوميات حمار مسقط الحزين، ولا قصائد شاعر مجنون مدفونة في رمال بوشر. وحدها الحكاية التي يقودها الميت الأعمى تستطيع أن توقظ مسقطك أيها المجنون/المتسرد/المتشرد/المنفي.
2.500 ر.ع.
نزهة مقالات من نوع أخر
لم أعد أقوى على مقاومة النوم، فهو يغريني، إلا أنني ما إن احتضنه حتی يهرب مني بسرعة فائقة، ولم اهنأ يوما بغفوة مريحة، ومنذ أن بدأت أتحين الفرص المناسبة للانقضاض عليه أجده يتلاشى، كأنه سراب نومي، وكنت كثيرا ما أخرج من شقتي إلى الشارع المجاور، ممسكا بيد نومي ليجعلني أحلم. وما إن أحلم حتى أجد نفسي قد عبرت الطريق الطويل الذي لم انتبه يوما المسافته، كل المسافات تقصر، وأرجع بأحلام أيضا، ولم أنتبه أيضا بالمسافة التي عبرتها عند رجوعي. كلها قصيرة، وقصرها هذا يربكني، فأنا لا أستطيع تذكر ما يصادفني أثناء سيري، كل شيء يذهب بسرعة، والأحلام الكثيرة تتطاير من حولي..
1.000 ر.ع.
أيقونة الحرية تستغيث بصلاح الدين
نحن أمام كاتبة مسرحية قديمة متجددة، وجدناها في ستينيات القرن الماضي لدى كلٍّ من ألفريد فرج ويسري الجندي وسعد الله ونوس عربياً، وبيتر فايس عالمياً، وغيرهم من الأسماء، حيث الكتابة التسجيلية التوثيقية الدرامية الواعية. د.عزة القصابي لديها الوعي الدرامي، والقدرة التي تكفل لها الغوص في عمق الأزمة الفلسطينية مع الاحتلال الغاشم، تلك الأزمة القديمة المتجددة، فما زال الجرح ينزف، ومن خلال الظلم يعتلي القمة للأسف. لكن تبقى كلمات القصابي وجُملها المرنة داخل النصوص الثلاثة بمثابة وثائق إدانة للواقع العربي المتخاذل، قبل أن يكون وسيلة لإدانة الاحتلال الغاشم.
4.000 ر.ع.
شهقة نبض
وحين رحل العابرون من حياتي؛ لم يتبقَ منهم سوى ذكرياتهم بداخلي، والتي سقتني كؤوسا من الألم، إلا أنني بِتُّ أرى نفسي بوضوح الآن من ناحية، وصرت أتعاطى مع الحياة بكل شجاعة من ناحية أخرى، وما إصداري هذا إلا ثمرة يانعة قطفتها من مجموع ذكرياتي...
1.500 ر.ع.
توظيف التاريخ والتراث في المسرح العربي الحديث
يتناول هذا الكتاب بالتحليل العميق بعض النماذج المسرحية المنتقاة من التاريخ العربي الإسلامي ، وذلك بغية دراستها ، وتحليلها ثم عقد مقارنة بين المـادة التاريخية التي استقى منها المبدع المسرحي موضوع وبين النص المسرحي المؤلف ، مما يتيح القارئ إكتشاف أهم ملامح العمل المسرحي ومدى تطابق أو اختلافه مع الواقعة التاريخية. ويتطرق إلى بعض النماذج التاريخية ، في محاولة التقدیم دراسة تحليلية نقدية ، عارضا أهم الإختلافات في الأحداث الواردة في النصوص المسرحية المنتقاة ، والأحداث الواردة في المادة التاريخية ، وكذلك مدى الاتفاق ، سواء كان في الموضوعات أو الشخصيات، وبذلك فأن الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو تقديم بعض النماذج المسرحية التي طرزتها أيادي المسرحي ين العرب ، وذلك في ثوب تاريخي باشراقات الحضارة العربية والإسلامية التي تفاوتت من مرحلة زمنية إلى أخرى . ولا يزال کتاب الدراما إلى عصرنا هذا، يجدون في المادة التاريخية مصدرا أساسيا ملهمة لهم ، وهو معين لا ينضب عبر العصور.
4.000 ر.ع.
ذكريات طالبة مغتربة
هذا الكتاب عبارة عن ملخص لتجربتي بالسكنات الداخلية بداخل عمان وخارجها طوال 15 سنة من حياتي الدراسية, حيث كانت نصف هذه المرحلة بالداخل, في حين كان نصفها الأخر بالخارج مقسما بين دولة خليجية ودولة أجنبية, وذلك في مرحلة الدراسات العليا.
2.000 ر.ع.
لا مزيد من النصوص
النصوص التي أكتبها لم تعد ملجأ لفرط ما توسلت الهدوء، إنها تقاوم من أجل أن تستكين الضوضاء تسلب تضاريسها، تطمس عنوانها وعنفوانها. كنت واجمة بتناقضي وقناعتي أمام نعش هذا النص الذي ظننته مقبورا لأرضي ما تبقى من ضميري لأنني في الحقيقة بعث نصوصي للرياح واختلقت الأمر وذلك قد يحدث للكاتب حينما يتخلى عن نفسه، وعن أحلامه ،وبقايا رفاته !
2.000 ر.ع.
ماتي تونغ
قريبا جدا سأصير يتيما، لن يترك أبي شيئا عدا حماره هذا، ونخيلا بعيدة في أرض بيت المال، سنعيش أنا وأمي وحيدين في بيت لا نملك له ملكيّة، ظل يحدثني أنه لن يترك شيئا عدانا، يقول أنتما ريحانتاي، أنا كنزه الوحيد، يريده عظيما قويا صلبا. لن أنساه، كان قد قال مرة: «أريدك كهذه الجبال»، أشّرت أصبع من يده اليمنى نحوها، كانت شامخة وقاسية، صلبة حمراء كدم الشهيد إذا جف على الأرض. «لا تنحن أبدا، حتى لو جاءك الموت افتح له قلبك، دعه يدخل مطمئنا ليوقف نبضاته، سترتد روحك إليه؛ لتنعشه في القبر، عش شامخا كهذه القمم التي جاورتنا الآن».
2.300 ر.ع.
حدثتني مسقط
كان اللقاء سريعا ولدقائق معدودة ، قال لي وبكل ثقة أن الكثيرة قناعاتي ستتغير بعد قراءة الكتاب ، وفعلا كان التغير كما أخبرني ولعل التغير الذي صنعه الكتاب كان على المستوى العملي ، أما التغيير الذي أحدثه اللقاء الأخير فقد كان درسا من أعظم دروس الحياة وللقاء الأخير طاقة على إحداث الكثير من التغيير خصوصا حين لا نعرف أن اللقاء الأخير إلا بعد فوات الأوان ، وكان آخر عهدي به کتاب ، الكتاب الذي احتفظت به لأشهر كذكرى قبل أن أتبين أن هنالك من هو أحق به وأن له مكانه الصحيح الذي لابد أن يعود إليه.
2.000 ر.ع.